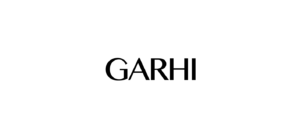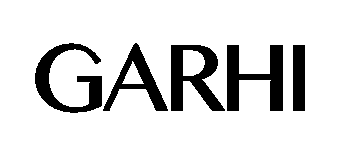نحتاج في بداية أي نقاش- للأسف- أن نعيد التعريف بأمور معروفة بالضرورة، وأن نعيد التأكيد على مسلمات أو أوليات غيرها أثبتها الزمن فصارت كالمسلمات، لكننا- كثقافة عامة في هذا الوقت- لا نمانع أبداً في إهدار بعض الوقت وحرق بعض الجهد في تكرار هذا الفعل الذهني.. إذا فلا بأس.
العمل الإعلامي خدمة عامة يقوم بها بعض أفراد المجتمع لخدمة مصلحة هذا المجتمع في المعرفة، والمقصود بهذه المعرفة هو كل أبواب المعرفة ابتداء من الخبر إلى الرأي مروراً بالمعلومات المجردة بما لا يخلو من الترفيه والإمتاع..
ولكون الإعلام خدمة عامة فهذا يستبعد بالضرورة أن يكون الإعلام كذلك وعكس ذلك في ذات الوقت، فأبدى أولويات المنطق أن الشيء لا يمكن أن يكون ذاته وعكسه في نفس الوقت، وعليه فما دام الإعلام خدمة عامة فهو لا يمكن أن يكون منحة ذهنية من الإعلامي أو عطاء يكسبه حقوقاً أكثر من تلك الحقوق التي تضمن له أداء الخدمة العامة بكفاءة.
أي أن حرية تداول المعلومات وحرية التعبير المرتبطة بالإعلام هما من الحقوق المكفولة للخدمة الإعلامية لا لشخص الإعلامي، وهما مكفولتان بضمان حصول متلقي الخدمة الإعلامية على الجودة التي يستحقها، لا لأنها امتياز طبيعي لشخص مقدم الخدمة.
وما دام الكلام قد جرنا إلى الحديث عن «المنطق»، فلا بأس أن نذكر بأن من قواعد المنطق أن الذاتي لا يجُب الموضوعي، بمعنى أن ضرب المثل بذاتي مثل شخص ما لا يعني استبعاد الموضوعي الذي ينطبق على كل ذات يشملها الموضوع.
أي أنه إذا دعا شخص ما مثلا إلى تطبيق قانون العقوبات على الجميع، فلا تجب المطالبة بتطبيق قانون العقوبات عليه – إذا كان قد خالفه حقا – الدعوة الموضوعية إلى تطبيق القانون على الجميع، حيث يشمل الموضوع، الذي هو ضرورة تطبيق القانون، كل ذات بما فيها ذات صاحب الدعوة إلى تطبيقه.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فلا مانع من أن نعرج على المطالبة بالتعجيل بإصدار القانون الموحد للإعلام الذي يفترض أن يحمي الصناعة نفسها، ويحمي معها المواطن صاحب الحقوق من أي عدوان قد يصيبه أو يصيب مصالحه الخاصة أو العامة جراء انحراف طرف من أطراف العملية الإعلامية عن مساره.
صحيح أن السائد في الوسط الإعلامي اليوم هو أن المواطن حامل الريموت كنترول هو صاحب السلطة الوحيدة في تقرير الخبيث من الطيب، إلا أن الأدوات التي يمكن أن يمارس بها هذا المواطن سلطته على الإعلام لا تقتصر على الريموت كنترول، لأنه يملك أداة مشروعة أخرى هي القانون.
(ملحوظة واجبة: ابتكرت البشرية القانون منذ آلاف السنين لحماية حقوق ومصالح الأفراد، وهو ابتكار لا يزال مستحسنا في المجتمعات المدنية التي يدعو إليها جل الإعلاميين ليل نهار، ومن أهم معالمها أنها مجتمعات يسودها هذا الابتكار الذي يدعى «القانون».)
وبالطبع من واجب العقل الجمعي لصناعة الإعلام أن يضع لها ميثاقا عاما يعفيها من مغبة الاصطدام بالقانون أو بأي شكل من أشكال سلطة المواطن، لكن هذا الميثاق لن يكون ملزما، خاصة إذا سمي بميثاق الشرف، حيث إن الشرف في حالتنا معامل يصعب الاحتكام له، ويستحيل الاكتفاء به.
وجدير بالذكر أن كل ما سبق لم يتعرض لمسألة «مقاييس جودة الإعلام» التي أطالب بجدية بمساواتها بمقاييس جودة المواد الغذائية التي يشترط المواطن أن تكون لها مواصفات قياسية يأمن على معدته بها، ومن حقه أن يطالب بما يشبهها فيما يتعلق بمادة تدخل عقله ووجدانه، وتتدخل في اختياراته وتوجه انتماءاته وتفضيلاته، وتصنع عقول أبنائه.
لو كانت لدينا هذه المعايير لما كانت كلمة «إعلامي» تساوي ذهنيا صورة شخص يجلس أمام الكاميرا ليتكلم بالساعات في رأيه الشخصي وفلسفته الذاتية في الأشياء.. لو كانت هناك معايير جودة للمادة الإعلامية لعرف المواطن – صاحب الحق الأصيل في المعرفة – أن ما يستهلكه يوميا هو أقل أشكال الإعلام جودة وأقلها تكلفة، بينما يستهلك نظيره في بلاد الله التقارير المصورة واستطلاعات الرأي والتحقيقات الاستقصائية وفنون الصحافة الإيجابية وعجلات الأخبار والوثائقيات التي تتكلف الملايين.
لو كان هناك ضابط لمعايير جودة الإعلام – أسوة ببرطمان الصلصة الذي تشترط له معايير جودة – لعرف المواطن أن «الرأي» في الإعلام هو أدنى درجات الجودة الإعلامية، وأنه يجب أن يأتي تاليا بعد المعلومة الخبرية (التي تتكلف كثيرا) والمعرفة المجردة (التي تتكلف كثيرا) والترفيه (الذي يتكلف كثيرا)، لأن حقه في الإعلام أولا أن يشاهده ليقول: الآن أعرف! لا أن يشاهده أولا ليقول: الآن أعرف رأي الأستاذ فلان!.
وللحديث بقية..