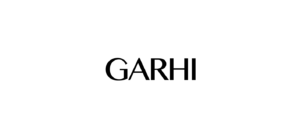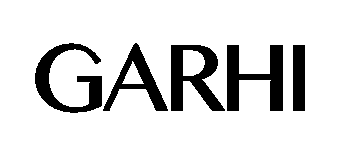بدت لي استقالة وزير التموين بناء على موجة استهجان من جانب الرأي العام وكأنها بادرة مناسبة لبدء الحديث عن محاربة الفساد، سواء على المستوى الشعبي الذي كان له دوره في عزل وزير التموين، أو على مستوى القيادة السياسية التي سارعت إلى قبول الاستقالة، أو ربما أجبرت الوزير عليها، لتفادي شبهة حماية الفساد أو التستر عليه.
دعونا أولا نتفق على أن الفساد وارد دائما في أي مجتمع ما دامت النفس البشرية على نقصها الذي فطرت عليه، وما دام قبولها للأخلاق والقيم العليا سطحيا حتى الآن، إجباريا بحكم القوانين الوضعية في أغلب الأوقات، غير ملزم ضميريا في مجتمعنا على الأقل.
ولأن المجتمعات البشرية تعرف أن الفساد ليس ظاهرة مؤقتة، فقد وضعت حدا ومعيارا للفساد لا يمكن القبول بأكثر منه وإلا أتى ذلك على ثمار التنمية ومكاسب البناء، والظاهر على هذا المعيار أن مصر تقف في منطقة ليست بسوء موقف سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال، لكنها أسوأ كثيرا من دول الشمال المتحضر.
وبالفحص الدقيق للقوائم التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية ولمؤشر الفساد الذي يصدره البنك الدولي نلاحظ الارتباط الطردي الوثيق بين مستويات إدراك الفساد ومكافحته من ناحية، وبين معدلات التنمية وتحسن الخدمات العامة وكفاءة الدولة بشكل عام، وهذا أمر قد دخل في حيز المسلمات التي لا جدال فيها بالفعل.
لكن الملحوظة الثانية التي يجب التوقف عندها هي أن الدول العشر ذات الترتيب الأعلى عالميا في هذه القوائم تشترك معا في عنصر جوهري يتعلق بالمحتوى الأخلاقي والتربوي في مناهج التعليم في هذه الدول، وبمقدار ما تبثه نظم التعليم – على اختلافها بين هذه الدول – من قيم تناهض الفساد وتستعدي المجتمع عليه من ضمن ما تحاربه من أشكال الجنوح والانحراف الأخرى.
تكتسب هذه الملحوظة أهمية كبرى إذا أضفنا إليها أن مفتاح أزمتنا في قضية محاربة الفساد هو أن نتفق على تعريف ذي معايير مصرية للفساد، وأيا كان هذا التعريف، فعلينا بعد وضعه أن نغرسه في نظمنا التعليمية والتربوية كعدو رئيسي للأمة، وبذلك تنشأ أجيال جديدة وقد تربت على أن الفساد جريمة لها بعدها الأخلاقي والضميري والفلسفي، وأنه شكل من أشكال الجنوح التي تحط بقيمة الإنسان الذي يقع فيه.
ويبدو من استقراء خريطة التفوق في مكافحة الفساد أن الإنفاق المباشر لهذه الدول على مكافحة الفساد أقل نسبيا عن إنفاق دول لم تدمج محاربة الفساد أخلاقيا وقيميا في نظمها التعليمية والتربوية، وهو ما يعني بالضرورة أن دمج قيم رفض الفساد والرشوة في نظم التعليم يوفر من النفقة العامة المباشرة الموجهة إلى مكافحة الفساد بعد وقوعه، ناهيك بالطبع عن الفارق الكبير بين تكلفة الوقاية وتكاليف العلاج.
والحقيقة أننا كمجتمع يتحسس إعادة بناء دولته نحتاج بشدة إلى تجريم واضح من الناحية الأخلاقية والضميرية لأفعال وتصرفات كثيرة يجرمها القانون بالفعل ولا وزن لها تقريبا في ميزان القيم عند المجتمع، كمخالفات المرور والتهرب الضريبي والتزوير في الأوراق الرسمية واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام وجرائم الكراهية والتمييز وغيرها الكثير مما تجرمه القوانين ولا يجرمه العرف المجتمعي.
وينعكس هذا الفراغ القيمي مباشرة على ممارسة هذه الأفعال التي لا تكفي النصوص القانونية وحدها لتحقيق الردع العام عنها، ببساطة لأن المواطن لا يدرك أنها جريمة في الأصل، ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الجرائم المؤصلة في قيمه كسرقة المال الخاص والاغتصاب والقتل.
هذه خطوة وحيدة يمكن البدء بها من خلال نظام التعليم ومن خلال وسائل التوعية المختلفة التي لا أعول عليها كثيرا مثل التعليم، لكنها ضرورية لتقديم الدرس الذي ينقص منظومتنا الاجتماعية، وهو أن الجرائم – ومن بينها الفساد – ليست بحسب التعريفات الفنية «ما يجرمه قانون العقوبات»، وإنما هي ما تعافه النفس وتنفر منه القلوب وتنهى عنه العقول من كل أشكال العدوان على حقوق الآخرين.