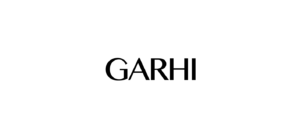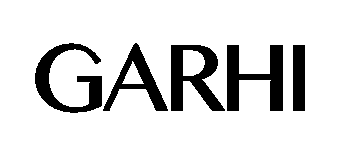هناك ما هو شخصى وما هو موضوعى، والمعروف بالضرورة أن اختلاط الاثنين، خاصة فيما يتعلق بالقانون الذى يفترض فيه الموضوعية البحتة، يؤدى إلى الاضطراب فى المجتمع الذى يحدث فيه هذا الاختلاط.
وعندما قال وزير العدل إن ابن عامل النظافة لا يصلح لأن يكون قاضيًا وإنه يكفيه أنه تعلم أصلا وإن هناك مهنًا تناسبه، لم تكن المصيبة أن تعليقه ينضح بالطبقية، ولا أنه يخلو من الذوق العام والحصافة المفترضة فى مسئول بهذا الوزن، وإنما كانت المصيبة فى أن الرجل المسئول بشكل كبير عن منظومة العدالة فى مصر قد خلط بين ما هو شخصى وما هو موضوعى بما يخل بمبدأ العدالة نفسه.
ويؤكد الدستور فى نصوصه وفى روحه أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون، وهذه قاعدة موضوعية يعرفها الرجل بالتأكيد، لكنه قدم عليها تصوره الشخصى، الذى ربما يتفق فيه معه الملايين من المصريين المقتنعين بتفوق الأغنياء على الفقراء نفسيا وأخلاقيا، لكن القانون «الموضوعى» لا يعترف مع هذا التصور ولو اتفق عليه الجميع، لأنه مازال وجهة نظر لا تحميها الحقيقة الموضوعية.
ولو كانت هناك لدى الناس أو الإدارة نظرية ما عن ارتباط السواء النفسى والسلامة الأخلاقية بمستوى اقتصادى أو اجتماعى معين، فلماذا لا تتحول هذه النظرية إلى قانون؟ لماذا لا يكون لدينا اختبار «موضوعى» للسواء النفسى والأخلاقى يمكن تطبيقه على جميع المتقدمين لمناصب حكومية سواء كانوا فقراء أو أغنياء؟
ولماذا لا تكون هناك ضمانة قانونية للتأكد من أن أى مسئول يتولى أى منصب يتعلق بحياة المواطنين يتمتع بالسلامة النفسية التى تحمى المجتمع المتعامل معه أو الواقع تحت رحمته من أمراضه النفسية ومركبات نقصه؟ بل لماذا لا يطبق هذا الاختبار الفرضى على المسئولين الحاليين لنعرف من منهم يصلح نفسيا وأخلاقيا لمنصبه؟
لست ضد التمايز والاختلاف بين الناس، ولست ضد الطبقية كحقيقة واقعية لها وجودها الحاكم فى مجتمعنا وفى أى مجتمع سواه، ولا أزعم أننى – كما طرح البعض دفاعًا عن تصريحات الوزير – قد أقبل بأن أزوج ابنتى لابن عامل نظافة، لكننى ضد أن ينسحب حكمى على عريس متقدم لابنتى على حكم الدولة على خريج متقدم لوظيفة عامة، فحكمى خاضع لوجهة نظرى ومزاجى الشخصى، وحكم الدولة يجب أن يكون خاضعًا للدستور والقانون.
وليس أقل من أن يعرف وزير العدل بحكم دراسته وعمله واختصاصه ودوره الإدارى أن العدالة تتحقق بمجموعة من الافتراضات التى قد لا تنطبق مع الواقع الفعلى، لكنها تتخذ كقاعدة تحكمية حماية لمبدأ العدالة نفسه، كفرضية أن الجهل بالقانون لا يعفى من المحاسبة، فهى بالتأكيد قاعدة لا يمكن تحققها أبدًا لأن الطبيعى والحقيقى هو أن المعرفة الكاملة بالقانون لن تتحقق فى أى مجتمع مهما بلغت درجة وعيه وتعليمه، لكن هذه الفرضية تحمى العدالة من مدعى الجهل بالقانون إذا رغبوا فى التفلت من المحاسبة.
وعلى هذا السياق تفترض العدالة تساوى الجميع أمام القانون كمبدأ عام، لا لأن الجميع متساوون حقًا فهذا مستحيل، لكنها فرضية تحكمية، أو كما يقول القانونيون «حيلة قانونية»، وظيفتها أن تحمى العدالة التى يفترض أن تكون موضوعية من أهواء الأفراد الذين قد يذهب كل واحد منهم وراء رأى شخصى يخل بموضوعية القوانين.
وما دام الشىء بالشىء يذكر، أتساءل عما إذا كان «كشف الهيئة»، وهو الوسيلة التى تستخدمها الإدارة فى الوقت الحالى لفرز المتقدمين اجتماعيًا ونفسيًا وسلوكيًا لشغل المناصب العامة فى كثير من الهيئات، كافيًا للقيام بهذا الدور، لأنه فى النهاية يعتمد على وجهة نظر الشخصية لبعض العاملين فى هذه الهيئات فى المتقدمين، أى فى النهاية هو مقياس غير موضوعى لمن يعجب ومن لا يعجب هؤلاء الموظفين، فهل تكفى هذه الأداة المعطوبة بالأهواء لتغطية الموضوعية المطلوبة التى تحقق المساواة أمام القانون؟
أظن أننا أمام حالة لا تقتصر على تصريح غير مدروس لمسئول رفيع فى الدولة، لكننا أمام إشارة مزعجة تدعونا إلى مراجعة القوانين المتعلقة باختيار وفرز المتقدمين للمناصب العامة فى بلادنا، ولعلها بداية.