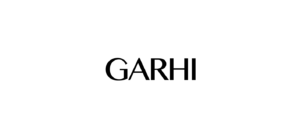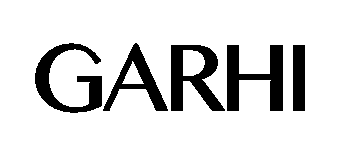قضيت قسطا من طفولتى فى بيت جدى الريفى ألهو مع أطفال العائلة فى حوش الدار الواسع، وفى الحقول الخضراء المحيطة، وأقضى طول اليوم معهم نرتكب من جرائم الطفولة ما يدخل تحت طائلة الإفساد فى الأرض وترويع الآمنين، حتى إذا ما حل الليل عدت إلى غرفتى الضيقة ذات السقف المرتفع فى الركن الشرقى من الدار لأقضى فيها سواد الليل حتى تعود شمس الصباح لنواصل اللعب من جديد.
وعلى الجدار المقابل لفراشى كان هناك تابلوه من الخشب المكسو بحرير أسود مشغول لصق فوقه تكوين بارز من النحاس الأصفر اللماع لوجه رجل باسم له وجه واضح الملامح، وشعره أجعد، وأنفه طويل مقوس بشكل لافت.
كان الضوء القادم من الردهة الخارجية ينعكس على الوجه النحاسى الصلب فيرتد منه وكأن الوجه نفسه يشع نورا، كان مشهدًا كهذا ليبدو رائعا اليوم، لكنه حينها كان مخيفا لطفل فى عمرى كان يظن أن الروح ستدب يوما ما فى الصور والتماثيل فى هذا المنزل العتيق لتطارده وتأكله لحما وعظاما.
وكان الإطار الأسود ذو الوجه النحاسى المهيب معلقا على مسمار أعلى كثيرا من أن أنزعه من مكانه، ولم يكن أمامى فى كل ليلة إلا أن أختبئ تحت الغطاء حتى يغلبنى النوم إلى اليوم التالى.
كانت جدتى تعتز بهذه الصورة كثيرا، ورفضت أكثر من مرة طلبى بنقلها من الغرفة، وكانت تقول إنه لو كان لا بد لأحد أن يترك الغرفة، فسيكون أنا لا جمال عبدالناصر، ولم أكن لأترك الغرفة التى يسهل القفز من شباكها إلى براح الشارع العمومى دون المرور بغرف الكبار فى الدار أبدا، حتى لو عادت الروح فى وجه عبدالناصر هذا وأكلنى حقا.
وكان أبى قد قضى ست سنوات على جبهة الصبر فى سيناء ينتظر الفرج والنصر بعد هزيمة يونيو، وظل طيلة حياته يحفظ لجمال عبدالناصر كراهية صادقة، وكان يكيل لسيرته كلما ذكرت السباب ويصب على اسمه أبشع اللعنات، وكانت جدتى تنهى عدوانه فى كل مرة بذات العبارة الصارمة: «اخرس! لا عشت ولا كنت!».. ثم تنظر إلى الصورة فى حالة أقرب إلى الوجد أو إلى الخدر قائلة: «ده جمال عبدالناصر»!
وما بين الصورة النحاسية المخيفة، والجدة العاشقة العنيدة، والأب الكاره الغاضب، كان اسم جمال عبدالناصر يمثل لى عقدة مركبة.. فكيف لأبى أن يصف صاحب الوجه الباسم الطيب الناضح بالأبوة بأنه سفاح؟! وكيف يقول على ذى الملامح المشعة المهيبة إنه كان جاهلا بالحكم أو مراهقا بالسياسة؟! كيف تقدر جدتى الرجل الغامض كل هذا التقدير، وكيف يقف أبى على نقيضها وأكثر من نفس الرجل؟!
وتمر السنوات لأكبر وأعرف أن هذا التطرف الشعورى تجاه جمال عبدالناصر جزء لا يتجزأ من شخصية الرجل نفسه، فإما أن تحبه إلى حافة العبادة، وإما أن تكرهه إلى حد البغض.. ولا وسط بين هذا وذاك.
ولذلك لم أتعجب عندما كنت أستمع للراحل العظيم، الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وهو يحكى فى قصيدته «يعيش جمال عبدالناصر» كيف أنه قضى زمنا فى سجونه وكيف أنه فى الوقت نفسه يهتف له بطول العمر حتى بعد موته، فهذه الحالة غير المنطقية هى ذاتها المنطق الذى يصف مشاعر المصريين تجاه عبدالناصر.
كان عبدالناصر يملك كل أداة يمكن أن يحلم بها أى زعيم سياسى فى التاريخ، ولهذه المنحة أحبه من أحبه بعد أن رأى فيه الموهبة الفطرية والملاءمة التاريخية، لكنه لم يحقق الإنجاز السياسى أو العسكرى أو الاقتصادى الذى يوازى هذه المعطيات ولذلك كرهه من كرهه.
مرت سنوات طوال منذ كانت الصورة النحاسية وحدها تحكم علاقتى بصاحب الأنف المقوس والابتسامة الأبوية العميقة، وأجد نفسى فى كل مناسبة أتأرجح بين شعور جارف بالحب تجاهه، وشعور جارف بالحنق عليه، وكلاهما شعور صادق فى منبعه ومبرراته، ورغم أننى كتبت كثيرا مما يفهم منه أننى معارض لأفكار عبدالناصر جملة وتفصيلا، إلا أننى فى الوقت نفسه لا أمرر فرصة أهتف فيها: يعيش جمال حتى فى موته!.. فالتناقض فى حضرة التناقض منتهى الاتساق.