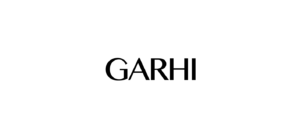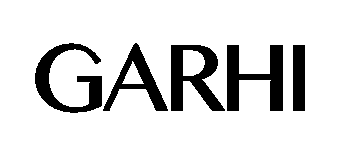فى الوقت الذى استعادت فيه مصر سيادتها على سيناء الحبيبة كانت أيدى العمران العصرى تمتد إلى صحراء دبى لتحولها اليوم إلى قاعدة عالمية للتجارة، رغم أنها تقع إلى الداخل بمئات الأميال عن خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وغابت نفس الأيدى عن سيناء التى تقع بحكم المزايا الجغرافية على ناصية هذه الخطوط الحيوية، وظلت قناة السويس مجرى ملاحيا تمر من خلاله المصالح بين الغرب المتقدم والشرق النامى مرور الكرام الذين لا يتركون وراءهم أى أثر.
وضاعت عقود ثلاثة وأكثر، كانت رؤية القيادة السياسية وقتها تتلخص فى أن عدم الفعل ذاته يعدم بالضرورة المخاطر التى قد يتضمنها هذا الفعل، وكانت النتيجة أن ظلت تنمية سيناء فكرة رومانسية تظهر فى مقال هنا أو كتاب هناك، لكنها لا تجد طريقا إلى أرض الواقع أبدا.
ظلت هذه البقعة خارج حسابات التنمية خوفا من الخطر الأمنى، فانتهت إلى ما هى عليه اليوم بلا تنمية ولا أمن، ولو كانت سيناء مركزا تجاريا وسيطا على خطوط الملاحة الرئيسية، ولو كانت معقلا لمصالح الشركات الأجنبية كهونج كونج وسنغافورة ودبى، لما كانت اليوم وكرا للإرهابيين الذين يتخذون من جبالها وكهوفها وصحرائها مخابئ وملاجئ.
وكما تأخر قرار تنمية محور قناة السويس تأخر كل شيء كان من شأنه أن يحقق لمصر الطفرة الاقتصادية التى كانت تحلم بها وتستحقها منذ خروجها عمليا من الكتلة الاشتراكية بانتهاء حرب أكتوبر.
جبنت الأنظمة السياسية المتعاقبة عن اتخاذ قرارات مثل تحرير سعر الصرف، وإطلاق آليات السوق الحرة، وهيكلة الدعم الحكومى، وهيكلة الجهاز الإدارى المترهل، وعن إصلاح البنية التشريعية، واستكمال مسيرة الديمقراطية الواجبة لحماية كل ذلك، وكان مبرر هذا التخاذل هو المخاوف الأمنية من رد فعل أى قرار، وكانت النتيجة أن أطيح بالدولة كاملة بثورة لم تترك عنصرا من عناصر «الأمن» قائما على قدمين إلا وخلخلته تماما.
فإذا بالجبن الذى سمى احتياطا وحكمة فى الحفاظ على الاستقرار يصبح القاتل الرئيسى للاستقرار، وهانحن نمر بسبع عجاف لا نعرف منها مخرجا غير اتخاذ القرارات المؤجلة فى اللحظات الأخيرة قبل الانهيار الكامل.
لكن الجبن الذى ولد فى نفس القيادة السياسية استشرى بالطبيعة فى نفوس الناس حتى أصبحت قرارات العلاج نفسها مخيفة، وحتى أصبح الشعب الذى يتوق للإصلاح هو نفسه الخصم الأول لهذا الإصلاح.
وصار الشعب كالمريض الذى يعرف أن المرض يأكل جسده، ولا يتوقف عن المطالبة بالعلاج، لكنه فى الوقت نفسه يرفض كل أشكال الدواء المتاح من حيث المبدأ وبالتفصيل!
وأصبحت الحلول المنطقية محل تشكيك وتساؤل، وأصبح أصحاب الحلول محل استياء ومعارضة، وكأن المريض الذى نتكلم عنه قد دخل فى عداوة مفتوحة مع الطبيب ومع الدواء ومن ثم مع فكرة الصحة نفسها.
كل ما تشهده مصر اليوم – وما قد تشهده فى الأشهر القليلة القادمة – من قرارات صعبة مؤجل أصلا، وهو مؤجل وليس مستبعدا حيث لا مجال لاستبعاده، فكيف يمكن لدولة أن تعيش فى اقتصاديات السوق الحرة ما يقرب من أربعين سنة بمبادئ اقتصادية تنتمى إلى اقتصاديات اشتراكية؟ وكيف يتصور الناس أن تصل بلادهم إلى غايتها عبر طريقين يسير كل منهما عكس الآخر؟
مدهش حقا أن أرى دعوات هنا وهناك تطالب بأن يخرج المسئولون على الناس لشرح الحالة وتفسير النهج وتيسير الفكرة، فكأنما صدق هؤلاء أن القرارات الاقتصادية – التى مازلت أراها مبدئية وغير كافية – قد وردت على ذهن صانع القرار على غفلة أو أنها من بنات أفكاره.
لقد كبر الورم حتى يكاد أن يهلك الجسد كله، ولم تعد الحلول الجراحية محل تفاوض أو تفكير، ولن تكون الجراحة سهلة لأنها تأخرت طويلا، ولم تعد لدينا رفاهية الانتظار أكثر من ذلك بعد أن أصبحت الدولة مهددة بالفشل الكامل حال استمرارها فى سياسات ما قبل الانفتاح الاقتصادى، فلماذا نستمر فى خداع أنفسنا وإلى متي؟
أما كفانا أنها شجاعة مؤجلة أصلا؟