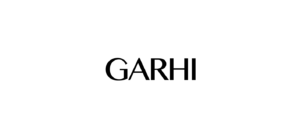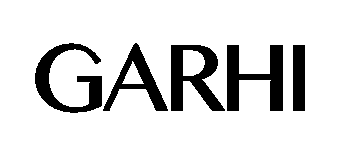كانت النخبة تتواصل فى بلدنا جيلا يسلم الراية للجيل التالى كما هى طبيعة الأمور فى أى مجتمع، فكان أرباب الصناعات يورثون أبناءهم المهنة وأسرار المهارة والإجادة فيها، وكان أرباب الفنون يورثون أصولها للنابهين من تلاميذهم، وكان يحدث أن تشارك نخبة المال فى بناء الطبقة التالية من نخبة العلم أو نخبة الفن.
كان على باشا إبراهيم مؤسس قصر العينى وأول نقيب للأطباء فى مصر وعميد الجراحين المصريين الذى قال فيه أمير الشعراء شوقى بعد أن عالج عاهل البلاد، السلطان حسين كامل، من مرض عضال: إنك إن جئته بذبيح الطير لأعاده حيا، لكنه كان قبل ذلك صبيا ابنا لفلاح رقيق الحال نزح من الريف إلى الإسكندرية سعيا وراء لقمة العيش.
والتفت بعض من نساء عائلة السمالوطى الثرية إلى ذكاء الصبى وفطنته واستعداده للتعلم، فألحقوه بالقسم الداخلى بالمدرسة الخديوية بدرب الجماميز ليستكمل دراسته حتى صار طبيب مصر الأول.
وكانت أم كلثوم قبل أن تصبح كوكبا للشرق ودرة تاجه الفنى فتاة حسنة الصوت نزحت من قرية بالدقهلية، ولم يكن طريقها نحو القمة ليقطع فى نفس الشوط لولا ما لقيته من دعم طلعت باشا حرب، الزعيم الوطنى والاقتصادى البارز، ودعم مصطفى أمين، الصحفى اللامع، ومن ورائه مؤسسة أخبار اليوم التى كانت حينها أحد أقوى المؤسسات الإعلامية فى العالم العربى كله.
وهكذا ظلت النخبة المصرية تتواصل جيلا فجيل على وتيرة منضبطة حتى جاءت ثورة يوليو لتطيح بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية لمصر، وتزيح النخبة القائمة تحت عناوين الرجعية أو الإقطاع أو الانتماء للعصر البائد أو أى عنوان آخر، وتبنى محلها نخبة جديدة كان أكثر ما يميزها أنها صنعت نفسها بنفسها دون صلة بالنخب السابقة.
وكانت هذه الصفة على وجه التحديد لعنة على آليات صناعة النخبة وتواصلها فى مصر، فقد أدت إلى عزلتها عن منهج نقل الخبرات والمعارف بين الأجيال، وفصلتها عن النخب التالية التى كتب عليها نتيجة لهذه اللعنة أن تتولى مصيرها بنفسها.
وعاشت نخبة يوليو على رءوس كل المناصب والمواقع والدرجات السياسية والاجتماعية لفترة أطول من المعتاد لجيل واحد لأنها تولت مقاليد قيادة المجتمع فى سن مبكرة نسبيا.
ولأنها لم تتخذ لنفسها خليفة تترك له هذا الميراث فقد خلدت فى مكانها مسيرة جيلين على الأقل، ودخلت مصر كلها التى كانت فتية شابة فى مطلع القرن موسما من الشيخوخة فى نهايات نفس القرن.. تيبست المفاصل وجفت الأفكار وانتهت طاقة الأحلام والطموح بعد أن بلغت هذه النخبة خريفها السبعين والثمانين، وأصبحت صبغة الشعر فريضة سياسية وفنية واجتماعية واقتصادية.
أكرر أن الشيخوخة ضربت كل القطاعات، وأن مبارك – رئيس البلاد – لم يكن أكبر سنا من رئيس أكبر أحزابها المعارضة ولا من شيخ أزهرها ولا من بطرك كنيستها ولا من مرشد جماعتها الإرهابية ولا من زعيم ممثليها ولا من نجمة جماهيرها.. كان الجميع قد تجاوز السبعين على أهون تقدير!
وكنا نحن شبابا ننظر إلى هذا الحال فنظن أننا لن نصيب قدرا من قيادة نخبة هذه الأمة أبدا، فالأجداد باقون فى مواقعهم حتى أن آباءنا قد هرموا ولم يصبهم الدور، فهل يصيبنا نحن؟
وبطول الاعتياد حسبنا أن الشيخوخة نفسها مؤهل للارتقاء، وظننا أن الكرش البارز واللغد المتدلى وذبحة الصدر والشعور المصبوغة والمستعارة وظننا أن الجلود المشدودة بفعل الجراحات والحقن هى طريقنا – بعد عمر طويل – إلى القمة، وأن سلم المجد يبدأ من سقوف دور المسنين.
كنا لذلك صيدا سهلا لأول من أشار لنا بخرافات ميدان الشباب الذى يحكم وصوت الشباب الذى لا يليق أن يعلو عليه صوت وتمكين الشباب الذى سيأتى حتما لو رشقنا رجال الأمن بالحجارة وأحرقنا المبانى العامة، بل لو أحرقنا «هالمدينة ونعمر واحدة أشرف».
والحقيقة أن فكرة تمكين الشباب نفسها فكرة معتلة، لأنها تعنى تزليل المناصب القيادية لمواطنين مؤهلهم الوحيد أنهم أصغر سنا، وكأننا نهدم صنما لنقيمه مرة ثانية، فهل انتهينا من الشيخوخة وكبر السن كمؤهل لننادى بحداثة السن كمؤهل بديل؟ أليست الكفاءة والمهارة وإبداع الأفكار هى الفيصل؟ أليست الموهبة هى المؤهل الذى يستحق التمكين، والفضيلة التى يجب أن تدفعها الأمة إلى صفوفها الأمامية، ولو كانت فى الثامنة من العمر أو كانت فى الثمانين؟