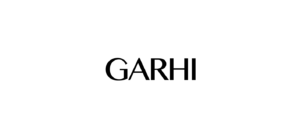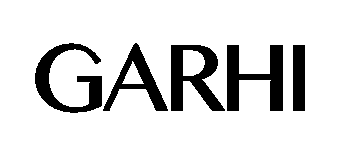الحيلة القانونية هى مجموعة من القواعد القانونية الافتراضية التى يعرف الجميع أنها لا تنطبق على الواقع، لكنهم فى الوقت نفسه يتخذونها أساسا وقاعدة لفكرة تطبيق القانون نفسها، ومن بينها مثلا الحيلة التى اخترعها الرومان وهى أنه لا يجوز الادعاء بالجهل بالقانون، لأن البديل هو ألا يسرى القانون على أحد، لأن الواقع أن درجة المعرفة بالقانون بين العامة لا يمكن فى أى حال أن تصل إلى نسبة المئة فى المئة، لكن هذه الحيلة تسد الباب أمام ادعاء الناس بأنهم كانوا يجهلون القانون فارتكبوا الجرائم.
ومن الحيل القانونية فى مجال السياسة افتراض أن الديمقراطية هى «حكم الشعب لنفسه بنفسه ولنفسه»، وهو افتراض يبدو رائعا، وهو كلام رائع حقا، لكنه ككل الكلام الرائع فى الدنيا كلام فارغ لا يعنى شيئا مما يبدو أنه قد يعنيه.
فالواقع أن التعريف الحقيقى للديمقراطية الحديثة هو أنها «حكم النخبة السياسية والاقتصادية للشعب عن طريق إيهامه بأنه له حق الاختيار الحر»، لكن الحيلة الوهمية المؤسسة تبدو أقل فجاجة من الواقع، ولهذا اتخذها الديمقراطيون قاعدة ورمزا رغم انقراض الديمقراطية المباشرة منذ عهد جمهورية أثينا الأولي، ورغم أن هذه الجمهورية كانت تقوم على ديمقراطية لا تعترف بالمواطنة إلا للسادة والوجهاء فقط.
لكنها الكذبة الحلوة التى تقوم عليها دائما أشياء كبيرة، وأحيانا ما تأتى هذه الأشياء الكثيرة بنتائج جيدة تعود على الناس رغم أنها مؤسسة على منطق باطل.
أما حيلتنا نحن، أهل الإعلام والصحافة والرأي، فهى أننا مهتمون بالشأن العام، وأن همنا الأول هو متلقى الخدمة الإعلامية، وأننا فى سبيل همنا بالشأن العام وبمصلحة المتلقي، التى تتمثل فى المعرفة والعلم بالأشياء والترفيه، نسعى لفرض قوانين تمنحنا المزيد من الحريات، ونسعى للتخلص من القيود.
لكن حيلتنا المؤسسة – ككل الحيل المؤسسة – ليست أكثر من حيلة نعرف جميعا أنها كاذبة، فالحقيقة أننا كغيرنا من أرباب المهن، نعمل من أجل فائدة العمل الذى قد يكون فى ذاته نبيلا، لكنه لا يفترض بالضرورة أننا نبلاء على طول الخط.
والواقع الذى نعرفه ويعرفه الجميع هو أن الإعلام صناعة، وأن هذه الصناعة تتغذى على تقديم الأخبار والآراء عن نخبة مقررة، بعضها سياسى وبعضها رياضى وبعضها فنى وبعضها اقتصادي، لكنها فى النهاية نخبة محدودة ومقررة ومكررة، وهى نخبة لا تمثل بالضرورة الشأن العام.
فأخبار نائب فى البرلمان مهتز العقل وأخبار رئيس ناد لكرة القدم فالت اللسان وأخبار ممثلة من الدرجة الثالثة متهمة بتيسير الدعارة ليست فى الحقيقة شأنا عاما، لكنها أخبار النخبة التى رأت صناعة الإعلام أنها تحقق القدر الأكبر من المتابعة لأنها الأردأ.
والأسوأ من ذلك أن تساهم صناعة الإعلام بنفسها فى إفساد الشأن العام، من حيث أنها تتحول إلى صانع منفرد للآراء ووجهات النظر، ومن حيث إنها تتحول إلى محتكر حصرى للحقيقة – وهذا ليس صحيحا، كما أنها فوق ذلك تستبعد الشأن العام من اهتماماتها تماما، بل وتقنع المتلقى بأن أى اهتمام بالشأن العام تطبيل وتدليل على منجزات السلطة الحاكمة.
ومن هنا يعمل الملايين من المصريين تحت الشمس الحارقة فى كل موقع فى البلاد ليبنوا مصرنا الجديدة، وليس إلى جوارهم صحفى أو كاتب رأي، وليست إلى جوارهم كاميرا توثق «الشأن العام» الذى يحفرونه فى الصخر.
من هنا نصدق أننا أصحاب مهمة نبيلة هدفها إهداء الحقيقة للقارئ والمشاهد عبر تضحياتنا التى لا تقدر بثمن، بينما القارئ والمشاهد يعمل هنا وهناك دون أن نكترث بعمله، بل ونقدم له شتائم رئيس النادى وضلالات النائب المعتوه والممثلة المغمورة على أنها شأنه العام.
الجدل الذى يرد على هذه النقطة دائما هو أن تغطية الإيجابيات ليس من عمل الإعلام، وأن الإعلام يجب دائما أن يقف على يسار السلطة، ويجب ألا يرى إلا سلبياتها.
يا سادتى الكرام، الملايين من مشاهديكم وقرائكم ومستمعيكم يعملون الآن فى شق عشرة آلاف كيلومتر جديد من الطرق وأنتم لا تعلمون، ويعملون فى حفر أربعة آلاف بئر جديدة وأنتم لا تعلمون، ويبنون مئات الآلاف من المساكن، ويرفعون عشرات الجسور، ويعملون فى المعامل والمصانع بحثا عن بلد جديد، فهل لهم حق فى أن يكون شأنهم العام هو شأنهم العام؟
هل لهم حق فى أن تكون أخبارهم وصورهم فى الصدارة بدلا من كل قبيح تفرضونه عليهم؟ وهل لهم صوت ينطقون به بدلا من أصواتهم التى احتكرتموها؟