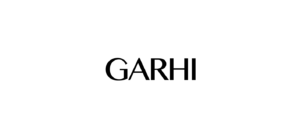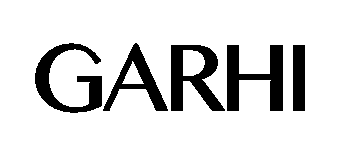يعرف أي شخص قرأ أول خمس صفحات من أي كتاب أكاديمي في السياسة جيدا أن مرحلة صندوق الاقتراع هي المرحلة الأخيرة للعملية الديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تبدأ بالصندوق، لكنها في الحقيقة تنتهي به كتتويج لمنظومة كبيرة تبدأ بالشارع السياسي وتنتهي بالتصويت في الانتخابات وتمر بمجموعة القوانين التي تنظم الممارسة السياسية في البلاد، والحياة السياسية كلها.
والحالة السياسية في مصر متردية على كل المستويات، سواء في الشارع السياسي الذي يضم الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات والتشكيلات والوحدات الاجتماعية المختلفة حتى مستوى الأسرة والفرد، أو في المنظومة القانونية التي تضم قوانين الانتخابات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المتعلقة بحريات إبداء الرأي والتجمع وتشكيل الجميعات ومن قبلها كلها الدستور، إلى مستوى الصندوق الذي يشهد مهازل – بمعايير الديمقراطية الأولية – من لحظة دعوة رئيس الجمهورية المواطنين إلى الانتخابات، وحتى انتهاء الفرز.
وتشير هذه المعطيات إلى أن «المنظومة السياسية المصرية» في وضعها الحالي لا تشبه أي منظومة ديمقراطية معروفة في العالم كله، فليست هناك في العالم كله أصوات تشترى بأكياس الأرز وعبوات الزيت والسكر، وليست هناك ديمقراطية في العالم يحكمها من يدفع أكثر في الدعاية الانتخابية، وليست هناك ديمقراطية بها حزب النور الذي يقدم مرشحين من «النصارى أعداء الله» ليقسموا على جسد المسيح ودمه أنهم سيدافعون عن الشريعة الإسلامية في البرلمان، وليست هناك ديمقراطية في العالم يتنافس على برلمانها هذا الخليط العجيب من المتناقضات والمتشابهات.
وهذا يعني بالضرورة أن ما يسري على الديمقراطيات الطبيعية من آليات لا يمكن أن يسري على الديمقراطية المصرية بحالتها المشوهة التي سلف النظر إليها باختصار مخل، فإذا كنا في منظومة يشير العقل إلى أن حتى آلية التصويت نفسها لن تجدي معها، فما بالك بآلية أكثر تعقيدا في مفهومها وممارستها، وأصعب في تطبيقها كالمقاطعة؟
المقاطعة آلية ديمقراطية تحتاج إلى شارع سياسي مؤثر، وفي حالة غياب هذا التأثير كما في الحالة المصرية تكون المقاطعة عبثا، لأنها في ذاتها تستهدف هز ميزان التعادل بين خصمين سياسيين يتنافسان على أصوات الناخبين، بطرف ثالث يضع ثقلا سلبيا غير مشارك ليكشف عن موقف سياسي مؤثر لكنه يعلن أنه أخرج نفسه من المعادلة بإرادته.
ومن ثم تحتاج المقاطعة أولا لمتنازعين سياسيين على أصوات الناخبين يهمهم في الأصل حجم المشاركة، وهو غير متوفر في الحالة المصرية، حيث سيحمد كل طرف ربه على أي عدد من الأصوات يحصل عليه ما دام قد حقق النسبة المطلوبة للفوز، حتى لو كانت نسبة المشاركة الكلية في الانتخابات خمسة أو عشرة بالمئة فقط كمان هو متوقع.
كما تحتاج إلى ثقل مقاطع مؤثر، وهو أيضا غير متوفر في الحالة المصرية، أولا لأن نسبة العزوف الطبيعية عن المشاركة السياسية مرتفعة أصلا، وحجم الغياب يبتلع أي محاولة جدية للمقاطعة بأبسط عملية حسابية، وثانيا لأن عدد المقاطعين الإيجابيين بقرارهم السياسي نسبة محدودة إذا ما استبعدنا منها الأطفال تحت السن القانونية الذين يعلنون على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم مقاطعون فيزيدون من حجم المقاطعة شكلا لا موضوعا.
والحقيقة أن المقاطعة لا تستهدف الانتخابات البرلمانية نفسها على ما فيها من عيوب قاتلة، وإنما تستهدف الرئيس السيسي الذي يضع هذا الاستحقاق المتأخر تتويجا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بعد الإطاحة بمرسي.. تستهدف المقاطعة إحراج الرجل في جدوى رؤيته السياسية لعملية استعادة الديمقراطية، وهي لعبة تسفيه صريحة.
لكن الملفت حقا هو أن الرئيس السيسي استجاب لهذه المناورة بجدية رغم عدم فاعليتها، وخرج ليقامر مرة أخرى على شعبيته وثقة الجماهير بشخصه، ويطلب من الشعب النزول للتصويت، وكأنه يضع ثقله الشعبي وراء الانتخابات ويطرح الثقة فيه مقابل نسبة الإقبال على التصويت.
وكان من الأجدى أن تترك دعوات المقاطعة للمنظومة السياسية القادرة وحدها على الفتك بأي آلية ديمقراطية مهما كانت، لأن العيب في السيستم كما قال الريس برايز في «فيلم ثقافي».