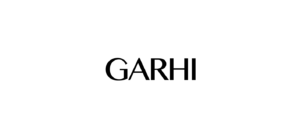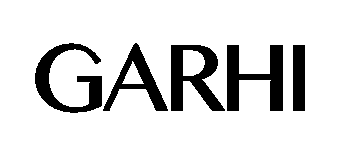لم تكن الدولة المصرية أحوج إلى إعلام قوى مؤثر أكثر مما هى اليوم، فبعد عقود من سيطرة الدولة الكاملة على الإعلام بكل وسائله، أصبحت الدولة بلا ذراع إعلامية تعتمد عليها فى وقت تحتاج فيه إلى فرض حد أدنى لا غنى عنه لأى دولة من السيطرة الذهنية والمعلوماتية على الشعب.
انفلتت القنوات والصحف الخاصة من تحت قبضة الدولة الثقيلة على مراحل خلال سنوات ما بعد ثورة يناير، واتجه كل منها إلى حيث تدفعه دوافع أصحابها السياسية والاقتصادية.
وفى الوقت نفسه، انزاح القسم الأكبر من جمهور وسائل الإعلام التقليدية إلى خانات المتابعة لشبكات التواصل الاجتماعى، وهى فضاء إعلامى لم تكن للدولة فى الأصل أى قوة تفرضها عليه، ولم تتمكن حتى الآن من صناعة تأثير حقيقى فيه، اللهم إلا ببعض المبادرات الفردية غير المنظمة من بعض المخلصين للدولة وهويتها.
وبقيت الدولة المصرية وسط هذه التيارات العنيفة بلا سند إعلامى غير القنوات التليفزيونية والصحف التى تملكها، وكلها – على سبيل الحصر- تعانى من نتائج تاريخ طويل من الإهمال والتسيب وضعف المهنية، إضافة إلى تركتها الضخمة من انعدام المصداقية بعد أن قضت عشرات السنين لا تفرز- على الأقل فيما يخص الدولة – إلا الكذب والتضليل.
وإذا أضيف كل ذلك إلى التشوه الذى أصاب الذهنية المصرية فى السنوات الأخيرة، والذى حولهم إلى جمهور، كثيرٌ منه سلبى لا يصدق إلا كل ما هو سيئ، ولا يتداول إلا كل ما هو كاذب، ولا يرفع إلا كل ما هو ردىء، فالصورة إذاً أشد قتامة حتى مما تبدو عليه.
كيف لدولة هذا حالها وموقفها مع الإعلام فيها أن تعبر عن نفسها؟ وكيف لها أن تتصل بجمهورها بالطرق وللأسباب التى تحتاج إليها الدول مع مواطنيها؟
ولنضرب مثالا على ذلك بأزمة الدولار المستمرة منذ شهور: ألم يكن من الممكن لدولة تملك إعلاما قويا أن تستخدم هذا الإعلام فى مخاطبة شعبها بخطاب ينفرهم من السوق السوداء، أو تضع به فى ذهن مواطنيها أن الضرر الذى يلحق بالمصلحة العامة يصيب مصالحهم الخاصة بالتأكيد، وتبث فيهم رسائل التوعية التى تدعو إلى تقديم المصلحة العامة على المكاسب الفردية السريعة؟
بالطبع، لا يمكن دفع عجلة التاريخ إلى الوراء، ولا يمكن العودة إلى عصور هيمنة الدولة واحتكارها لوسائل الإعلام، فالزمن غير الزمن أولا، لكن الأهم هو أن هذه الهيمنة لم تكن فى أفضل أحوالها تحقق للدولة المصرية أهدافها من الإعلام، حيث افتقرت دائما إلى ثقة المواطن فيها، والإعلام بلا ثقة يفقد كلية قدرته على التأثير.
أما الحل الذى يأتى فى سياق التقدم الطبيعى لعجلة الزمن فهو ضرورة سعى الدولة إلى تجديد ثروتها من الإعلام العام الذى تملكه بالفعل، بحيث يدخل إلى حيز المنافسة على كعكة صناعة الوعى فى البلاد بحصة ملائمة، فى وقتٍ تؤكد فيه الدولة بكل صورها الرسمية أننا نتعرض لمواجهة مع أعدائنا الإقليميين تعتمد نتيجتها بشكل كبير على صناعة هذا الوعى.
ولا يمكن أن تسير الاتجاهات العالمية فى مجال الدفاع بالتحديد نحو أمن المعلومات وإدارة التوجيه الذهنى على شبكات التواصل الاجتماعى، بينما الدولة المصرية تخوض حروبها تلك بالإعلام التقليدى شبه البدائى الذى تملكه، ودون أن يكون لها وجود يذكر على موجات الإعلام الجديدة.
عندما قرر المصريون القدماء إعلان الحرب على الغزاة الهكسوس، كانت خطة المواجهة تقوم على أن يصنع المصريون عجلات حربية كتلك العجلات التى امتطاها جنود الهكسوس لغزو البلاد، وقياسا على هذا المثل التاريخى لا يمكن أن تقاتل الدولة المصرية فى حرب يمتطى جنودها موجات البث الفضائى ونبضات البث الإنترنتى دون أن يكون لها ثقلها على هذه الموجات وتلك النبضات.
الدولة – وأى قوة سياسية وليس بالضرورة أن تكون دولة – تحتاج إلى ذراع إعلامية مؤثرة، والواقع يقول، للأسف، إن مصر تدير مصالحها، وتدافع عن وعى أبنائها، وتبنى الوجدان وتصنع الأمل وتكافح الضلالات، وتعد العقول للمستقبل وتصد العدا بذراع مقطوعة.