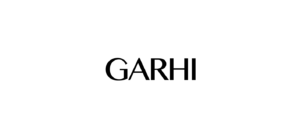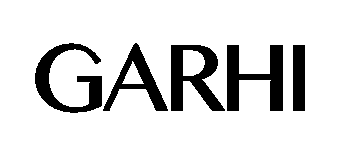كم كان صادما ما فاجأتنا به وسائل الإعلام عن ذلك اللص بدرجة موظف عام الذي عثرت هيئة الرقابة الإدارية بحوزته لحظة القبض عليه ما يوازي مئة وخمسين مليونا نقدا من العملة المصرية والعملات الصعبة، ومرجع الصدمة ليس في جريمة الفساد التي تراجعت كثيرا قدرتها على إثارة الدهشة خلال العقود الثلاثة الماضية، وإنما هي قدرة ورغبة مجرم في الافتراس إلى ما بعد الشبع والتخمة إلى هذه الدرجة المذهلة.
وهرع كثيرون إلى مراجع علم الجريمة والعقاب الذي ينطوي على الكثير من الجذوع العلمية التي ترد السلوك الإجرامي إلى أسباب وراثية وأسباب اجتماعية وأخرى نفسية، وغرقت وسائل الإعلام العامة والاجتماعية بكسور هذه النظريات مفردة ومجتمعة، وشملت التفسيرات الاجتهادية كل النظريات عدا النظرية الحقيقية التي تفسر هذا السلوك الإجرامي الاستثنائي.
وأصف هذا السلوك بالاستثنائي عفوا، فهو في الحقيقة لن يبدو استثنائيا إذا ما قطعنا المجتمع المصري الحالي بنظرة طولية يتجلى منها أن ما كان استثنائيا يوما ما لم يعد استثنائيا، وإنما أصبح سمة سائدة على مجتمعنا من التسيب والاضطراب الأخلاقي الجماعي.
وبعد استمطار الرحمات على أرواح السابقين من المجرمين الذين كانوا يشبعون، وبعد ضرب الكف بكف عجبا ومصمصة الشفاه، وبعد استبعاد التفسيرات السطحية أو المعزولة منطقيا أو تلك التي تنتمي إلى متاحف الفكر الاجتماعي والنفسي، دعونا نذهب مباشرة إلى التفسير المنطقي لجريمة هذا شكلها.
الحقيقة أن الجريمة لا يمكن أن تفسر بمعزل عن المؤثر الاجتماعي الذي لا أقصد به البيئة التي تربى فيها المجرم أو الجانح من أهل وأقارب وأصدقاء، بل أقصد المؤثر الاجتماعي الأوسع الذي يضم حزمة القيم والقواعد الاجتماعية والأخلاقية والقوانين وغيرها من الأربطة التي تشد وثاق أي مجتمع.
ومن زاوية هذا المؤثر الاجتماعي، يمكن القول بضمير مرتاح أن المجتمع المصري الحالي لا يمكن أن تنطبق عليه صفة المجتمع أصلا، من حيث فقدانه للركن الرئيسي في هذه الصفة وهو الانضباط على أساس اتفاق جوهري بين أفراد الجماعة البشرية على معايير ملائمة، والحق أننا على العكس من ذلك، فنحن جماعة بشرية أجمعت على عدم الاتفاق فيما بينها على اتباع هذه المعايير الملائمة.
السبب في ذلك يعود إلى ما أصاب الأمة المصرية خلال العقود الثلاثة الماضية من تفكك واهتراء قيمي أعدم فرص هذا التوافق المجتمعي على المعايير، فأصبح الصواب والخطأ مسألة شخصية من ناحية قناعات الأفراد، فالصواب هو ما أراه صوابا، والخطأ هو ما أراه خطأ، وصواب الآخرين مرتبط برأيي فيهم وكذلك خطاياهم، ولا وجود لمعيار اتفاقي على هذه القيمة الأولية التي تعد بجدارة البند الأول والمقيم في العقد الاجتماعي.
نعرف أن المجرم الذي يرتكب جريمة كتلك لا يعرف قيمة كالضمير الذي كان من الممكن– إن وجد– أن يردعه ولو قليلا عن النهش في لحم تسعين مليون إنسان في نفس اللحظة، وأن الصواب في نظره هو إشباع حاجاته ورغباته الشخصية فحسب، وأن الخطأ هو أن يترك مالا في عهدته دون أن يفيد منه هذه الحاجات وتلك الرغبات.
والأسوأ هو أن قيمة الضمير، وغيرها من قصبات حزمة القيم المؤسسة للمجتمعات الصالحة، قيمة غائبة عن المجتمع بشكل عام، ويكاد يكون شاملا جماعيا، وهذا الغياب للقيم والمعايير لا يؤدي فقط إلى تفشي السلوكيات الانحرافية في المجتمع، وإنما يؤدي إلى تفكيك قدرة هذا المجتمع على إلزام أفراده بالأعمال التي يفترض أن يقوموا بها في إطار مجتمعهم ولخدمته.
ونتيجة لعجز المجتمع عن فرض هذا التوزيع الطبيعي للأدوار على أفراده تنهار قيمة العمل نفسها، ويسود الكسل والتراخي والخمول، ويغلب على أفكار الناس تحقير العمل والعاملين، وتغيب الجودة أصلا ومظهرا، وينتهي المجتمع منزوع القدرة على الفعل الجماعي الذي هو قلب فكرة الاجتماع ذاتها.
الجريمة الحقيقية أكبر من جريمة الموظف المرتشي، وأكبر من حجم السرقة ومن حجم ما أهدرته هذه السرقة من أموال على الدولة، وإنما هي الجريمة التي ارتكبت بحق هذا الشعب واستخدمت فيها كل الأدوات المشروعة وغير المشروعة، ووظفت فيها كل أذرع الفساد والإفساد، حتى أتت على قيم العنصر المصري العظيم وتركته على هذا الحال المحزن.