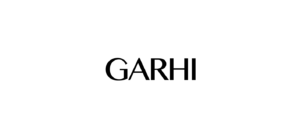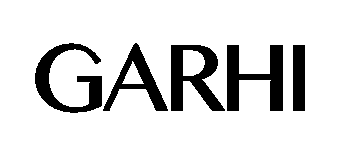كثيرون يحلمون بدولة مدنية في مصر، دولة لا تحكمها أسرة ولا عصابة، ولا تحكمها جماعة رجعية ولا حتى الجيش.. كثيرون يحلمون بأن تكون لنا دولة يسودها القانون الذي يقف أمامه الجميع سواسية، كما يقفون أمام الفرص الاجتماعية والاقتصادية سواسية، ويا حبذا لو كانت دولة ترعى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والشفافية أيضا.
لكن الدولة المدنية خطوة لها موقعها على خط سير التطور البشري، تأتي دائما بعد قطع أشواط على هذا الخط كنتيجة يصنعها منطق التطور ولا تصنعها الأحلام والأمنيات الطيبة.
وتفيد أدبيات تاريخ النظم السياسية والاجتماعية بأن التجمعات البشرية تنشأ من بذرة الأسرة إلى ساق العشيرة إلى شجرة القبيلة، وفي نقلة من الأسرة إلى العشيرة ومن العشيرة إلى القبيلة تتعاظم المصالح المشتركة بين أفراد الجماعة البشرية، وتتراجع أهمية روابط الدم المباشرة أمام هذه المصالح.
ويقول علماء الاجتماع إن الدولة المدنية هي المرحلة التي تتغلب فيها مصالح الاجتماع على العواطف التي تربط أبناء القبيلة، وإن هذه الروابط العاطفية الباقية تظل شوكة في حلق المشروع المدني حتى تزول نهائيا.
ويمكن القول إن مصر مرت منذ نشأتها بجولات صعود وهبوط على سلَّم المدنية، وأنها في الوقت الحالي تعيش مرحلة تأخر تغلب فيها سيكولوجية القبيلة على فكرة المدنية.
فالمصريون اليوم لا يتعاملون مع أزماتهم وقضاياهم القومية من زاوية أنهم مصريون، وإنما من زوايا القبائل الصغرى التي ينتمون إليها، فإذا واجه الأطباء أزمة تكون نفرتهم نفرة لقبيلة الأطباء لا نفرة مواطنين مصريين يواجهون مشكلة داخل مجتمعهم.
فيرى الأطباء حينها أنهم جماعة منفصلة لها عناصر وحدتها، ولديها عناصر استقلالها عن الآخرين، وأنهم يجب أن يتماسكوا من أجل حماية هذه العناصر وإلا هلكت القبيلة كلها، من حيث أن بقاء القبيلة هو الضمانة الوحيدة لبقاء الفرد.
وطبيعي جدا أن تتضمن إجراءات حماية عناصر الانفصال والتميز والاستقلال قدرا على بأس به من أدبيات الشعور بالاضطهاد (راجع انتفاضة نقابة الأطباء)، وقدرا لا بأس به من أدبيات التعالي ونكران حق الآخر في الاختلاف (أنظر إلى الريشة التي وضعتها قبيلة الصحفيين على رأسها في نزاعها مع قبيلة الداخلية التي لا تقبل أن تضع أي قبيلة غيرها ريشا على رأسها).
والأسوأ من ذلك هو أن بقية النسيج الوطني ستتعامل مع هوجة القبيلة الصغرى، كما تتعامل تجمعات القبائل مع أي قبيلة فيها تأخذها نعرة الجاهلية، فالجاهلية في العادة تجر جاهلية مقابلة، وعندها يتحول المجتمع – المدني افتراضا – إلى سوق للتناحر والتزيد وتبادل معلقات الفخر والهجاء والشتيمة.
وليس مدهشا أن تتضمن وسائل القبيلة في الدفاع عن وجودها، وفي سبيل تعزيز مظهرها الجاهلي، قدرا واضحا من العدوان المتبادل بين القبيلة وأبنائها الذين قد تظهر عليهم أعراض “الاختلاف”، فالاختلاف يولد الاستقلال، والاستقلال هو العدو الأول للقبيلة، ولهذا تكون سيوف القبيلة أعجل وأمضى في لحوم أبنائها الذين يخالفونها الرأي من سيوف العدا.
ولن تنسى القبيلة أن تصنع لنفسها أصناما من شخوص كانوا يوما ما بشرا سويا، وحولتهم أساطير صناعة المجد القبلي إلى أبطال، ثم إلى أصنام ترفع على أرفف القدسية والحصانة ولا تمس، لتصبح بعد فترة من الزمن جزءا من تابوهات القبيلة ومن عناصر اجتماعها أيضا.
وهكذا صارت كل فئة قبيلة، وصار لكل قبيلة نسيجها ومعتقدها وأصنامها وآلياتها الجاهلية، وصارت الدولة المدنية بصورتها العصرية أملا تستبعده كل المعطيات.
وهنا تطرح القومية المصرية الحل في ذاتها، فهي رابطة قادرة على احتواء هذه الخلافات القبائلية لصالح انتماء وطني أوسع قد تكون له عصبيته أيضا، لكنه كفيل في الوقت ذاته بأن يقيم دولة مدنية عصرية تستفيد من قوة الانتماء التي تميز العلاقة بين القبيلة وأبنائها.
الدولة القومية وقومية الدولة نظيران منطقيان في خط سير التطور للنظم السياسية والاجتماعية، ناهيك عن أنهما الآن ضرورة عملية للحفاظ على هيكل الدولة المصرية أمام الأمراض التي تتناوبه.